الناقدة منال رضوان تكتب سردية التعدد الرمزي والحوار الوجودي في رواية واثق الجلبي: من السيمرغ إلى الشيخ يوسف.


في روايته الصادرة عن دار ومطبعة العصامي للطباعة، يقدم الأديب والشاعر العراقي واثق الجلبي عملًا سرديًا بالغ الكثافة والرمزية، لا ينحصر في حدود الزمان والمكان، بل يتعداهما ليشكّل فسيفساء فكرية وروحية وحضارية، تتماس مع أطياف متعددة من الموروث الديني والأسطوري والفلسفي، ومن خلال هذا البناء المركّب، تتجلّى سردية التعدد الرمزي، والحوار الوجودي التي يتبناها النص، ويجعل منها ساحة تأمل ومساءلة كبرى؛ حيث تتجاور الأصوات، وتتقاطع المرجعيات، دون أن تذوب في سلطة مركزية واحدة.
ينسج الجلبي نسيجًا من الرمز والفلسفة والتأمل، ويستدعي عبر لغة شعرية عالية عالمًا مزدوجًا يمزج فيه بين الواقع والحلم، يرتكز على أسطورة الطيور ورحلتها نحو المعرفة، متكئًا على إرث صوفي عميق، يُذكّر بـ"منطق الطير" لفريد الدين العطار، ليتخذ النص هيئة سردية رمزية؛ حيث يمثل الطاووس الغريب الباحث عن الحقيقة، بينما يُقدَّم السيمرغ بوصفه ملكًا مُتخيَّلًا للطيور، يطالب بالطاعة والاندماج الكلي.
حتى يمضي العمل بنا في تقاطعات كثيفة بين النور والظلام، الذات والآخر، الزيف والحقيقة؛ ليرصد صراع الفرد في مواجهة التبعية ومسخ الهوية، الطاووس هنا، بعين الناقد لا العابد، يفضح الخضوع الجماعي ويعيد الاعتبار لسؤال الوجود والمعرفة، يتماهى الليل فيه مع الشعور بالاغتراب، ومعه تبرز الطيور كشخوص رمزية؛ فنجد على سبيل المثال النعام كرمز للخنوع، والهدهد كدليل على الحكمة، بينما يمثل الغراب ظل الحكمة المرفوضة والمعلم الجافي.
ومن الملاحظ أن لغة الجلبي تتشح بالإيحاء والتكثيف، وتحمل نبرة عرفانية تضيء الدلالات من دون أن تستهلكها أو تستنزف حواشيها، فيما يشكّل الحوار النهائي بين الطاووس والسيمرغ ذروة النص الصادمة، إذ يقلب المعادلة:
ليس الإله من يصنع الهوية، بل السائل، الباحث، الخارج عن الجماعة.
لنلاحظ أنه منذ العنوان وحتى الصفحة الأخيرة، وضعنا بإزاء سرد يتأسس على سطور فكرية وزمانية شديدة التعقيد؛ حيث يتقاطع صوت السيمرغ فيها، اذلك لطائر الأسطوري الحاكم، مع صوت الشيخ يوسف، الإمام المعتزل، ومع صوت تلميذه حسن، الرافض لعصره ولوسائل تواصله، جميعها أصوات لا تنصهر في صوت المؤلف، بل تتجادل وتفترق وتتنافر، مانحة النص صفة الحوارية الباختينية بامتياز؛ فالشيخ يوسف، برمزيته الدينية والمعرفية، لا يحضر كبطل مهيمن، بل كصوت ضمن أصوات، يراجع المؤسسة الدينية ويتأمل انزياحاتها من الداخل:
"أصبح الدين لعقًا على ألسنتهم ولهثوا خلف المال والنساء..."،
بينما يمثّل حسن، التلميذ الرافض للحداثة، وجهًا آخر من وجوه الأزمة، في تمرده على الحاضر وتمسكه بالماضي دون فحص أو تمحيص.
في السياق ذاته، تتحول الأسطورة إلى وعاء يستوعب هذه الأصوات كلها، فتظهر شخصية السيمرغ – الحاكم الطاووسي – بوصفها رمزًا مركزيًا يُعاد مساءلته وتفكيكه، في لحظة تمرد وجودي حين تنقلب عليه الطيور ويعود السرب إلى اللحظة البكر. هذا الانقلاب الأسطوري لا يُقرأ باعتباره استعادة لحكاية فارسية، بل باعتباره إسقاطًا على أزمة السلطة والرمز والمعنى في عالم تتنازعه بعض الأسئلة الكبرى:
من يقود؟ من يملك الحقيقة؟ من يرسم طريق الخلاص؟
هنا لا يقف الجلبي عند الأسطورة فحسب، بل يوظف الدين والتاريخ والشعر والفلسفة، بلغة مكثفة، ذات طابع مجازي رفيع، تفتح أفق التأويل أمام القارئ، وتدفعه إلى التورط في إنتاج المعنى؛ نقرأ مثلاً: "النور بيّن، والظلام واضح... فإذا انطفأت مشكاة العين شعلة القلب تبقيك حيًا، فإذا انطفأت شعلة القلب فمن يريك الطريق؟".
نص كهذا لا يقدّم جوابًا بقدر ما يفتح سؤالًا تتناسل أسئلة عديدة منه، وتضع القارئ في قلب المأزق الوجودي ذاته الذي تحياه الشخصيات.
كما أننا نجد الحوار بين الشخصيات لا ينقل المعلومة فقط، بل يكشف تمثلاتها الفكرية، ويعرّي تناقضاتها، ويجعلها مرآة للقارئ والمجتمع معًا؛ ففي خطاب الشيخ يوسف، كما في اعتراضات حسن، كما في أقوال السيمرغ والحمامة الحكيمة، تتكثف رؤى العالم المختلفة: الجدلي، والصوفي، والتاريخي، والثوري، والتشكيكي، وهذه كلها تنخرط في ساحة سردية واحدة، تعيد تشكيل وعي المتلقي، لا عبر التسليم بل عبر الاستنفار الفكري، والمجازفة التأويلية.
ولا يغيب عن العمل استحضاره المادي لمظاهر الانهيار الاجتماعي والسياسي، كما في وصفه شديد الملمح لبغداد:
"أطبق الظلم على عاصمة العالم، أورث المآسي... اختلطت العمائم البيض والسود"،
لتُظهر أن خراب المعنى وخراب المدينة وجهان لعملة واحدة، هذه الخلفية المأساوية تُعطي الحوار بين الشخصيات بعدًا آخر؛ حيث لا يعود الحوار ذهنيًا فقط، بل يصبح صرخة في وجه واقع مفكك ومضلل.
ولا يغيب عن الذكر هذه اللمحة الشعرية التي تتخلل الفصول؛ إذ أنها وقفات شعرية كتبها الجلبي بنفسه، تشكّل مكاشفات تأملية تعيد ترتيب ما فُكك سرديًا، كما في قوله:
"يا راكبًا ظهر المياه تكبّرا ** في فتنة زلّت بك القدمان"
وهي أبيات تُذكّر القارئ بأنّ الخطاب داخل العمل ليس فقط خطاب العقل، بل أيضًا خطاب القلب والروح، وأنّ فهم الإنسان لا يكتمل إلا بجمع الأضداد: العلم والإيمان، الشك واليقين، الماضي والحاضر.
فهذا العمل لا يقدم سردًا تاريخيًا أو دينيًا أو أسطوريًا بالمعنى التقليدي؛ بل تترسخ عبر هذه الحقول سردية معرفية – رمزية متكاملة، تُسائل الفرد والمجتمع، وتفتح أفقًا واسعًا للتأمل في معنى الإنسان في عالمه المتغير.
ولعل نهاية الرواية – التي تنتهي ببداية جديدة – تجسّد هذا المعنى الباطني العميق:
أن لا يقين نهائي، وأنّ البحث عن الحقيقة هو الهاجس الإنساني الأول والأخير، وأنّ الخلاص لا يأتي من الخارج، بل من حوار الإنسان مع ذاته، ومع الآخر، ومع الزمان المتقلب.
بهذا، يكون الكاتب قد نسج عملًا روائيًا ذا طابع موسوعي، يُعيد الاعتبار للسرد بوصفه أداة للبحث والتأمل والفعل، ويُقدّم نصًا قابلًا لإعادة القراءة، والانفتاح على تعددية الأصوات والدلالات، في زمن أحوج ما يكون فيه الإنسان إلى استعادة صوته الخاص.



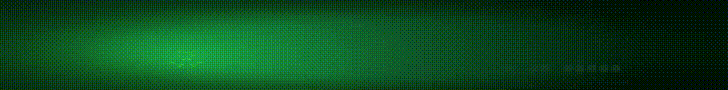


















 تفحم طفليين في حريق هائل بشبين القناطر
تفحم طفليين في حريق هائل بشبين القناطر ربة منزل تقتل عشيقها بمساعدة اخر وتفصل جسدة عن رأسه
ربة منزل تقتل عشيقها بمساعدة اخر وتفصل جسدة عن رأسه سوهاج .. مالك مصنع فوم يوضح سبب الحريق الضخم بمصنعه
سوهاج .. مالك مصنع فوم يوضح سبب الحريق الضخم بمصنعه شهيد اثناء توزيع التمر علي الصائمين أثناء الاذان بقها
شهيد اثناء توزيع التمر علي الصائمين أثناء الاذان بقها منتخب مصر للناشئين يُنهي استعداداته للمشاركة في بطولة أفريقيا للجولف بتونس
منتخب مصر للناشئين يُنهي استعداداته للمشاركة في بطولة أفريقيا للجولف بتونس